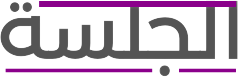في قسم الاستقبال في أحد المستشفيات الخاصة في دمشق، تقترب سيدة مسنّة من أهالي المرضى لتحيتهم بعدما عرفت أنهم لبنانيون. السيدة ذات الهندام المتواضع، عادت لتوّها من صور لتمضي الأعياد مع أقربائها في ريف حمص.
منذ بداية الحرب، نزحت إلى المدينة اللبنانية حيث يعمل ولداها منذ أكثر من عشرين عاماً في قطاع البناء لصالح مقاول لبناني. لم تحصل وحدها على بطاقة لجوء من مفوّضية اللاجئين في الأمم المتحدة عام 2011، بل حصل عليها أيضاً ولداها وعائلتاهما رغم أنهم من سكان البلد. تقرّ بفوائد البطاقة التي وفّرت لها مساعدات مالية وتموينية شهرية، فضلاً عن الاستشفاء. أما ولداها فقد عزّزت تلك المساعدات مداخيلهما الوفيرة «التي لم تنقطع لا في أيام العزّ حينما كان الدولار بـ 1500 ليرة، ولا بعد انهيار العملة». تشير إلى أن ولديها عيّنة بسيطة من آلاف السوريين الذين تقوم على أكتافهم المصالح في لبنان من الزراعة إلى الصناعة والبناء ونواطير المباني والمزارع. لكنها تأسف لأن «الأمم» شطبت بطاقة ولديها العام الماضي خلال إعادة هيكلة المستفيدين. السيدة واحدة من الآلاف من حاملي بطاقة اللجوء الذين يتنقّلون بأريحية عبر الحدود. حتى الآن، ترفض العودة إلى بلدها برغم استقرار الوضع في مسقط رأسها. رغم العنصرية والتحريض على النازحين، «هنا أحسن»، تقصد لبنان. «فرص العمل كثيرة والأجور بالدولار».
لم أتحمّل الإهانات
المغريات اللبنانية تدفع السيدة «لتحمّل سوء المعاملة». وفي حال صمد كثر، فإن آخرين عادوا إلى سوريا بعدما استتبّ الأمن. «جهنّم سوريا ولا جنّة لبنان»، قال طارق الذي ترك عام 2020 وظيفته كطباخ رئيسي في سلسلة مطاعم لبنانية فاخرة «لأنني لم أتحمل الإهانات». لم يحظَ منذ ذلك الحين بوظيفة مماثلة. مع ذلك، يرفض العودة إلى لبنان. يؤكد أن «التمييز اللبناني لم يكن سلوكاً عاماً قبل أزمة النزوح السوري. بل كان معياره علاقة المنطقة أو الطائفة بالنظام السوري. الآن، صار الطفل اللبناني ينشأ على الكراهية والفوقية». بخلاف ما يشيع بعض اللبنانيين عن أن سوريا كلها نزحت إلى لبنان. كثر لبّوا نداء وطنهم بعد الحرب. منهم أيهم الذي كان يقيم في الشوف. قسم من عائلته التي تتحدّر من السويداء مستقرّ منذ سنوات في جبل لبنان حيث لا يميّز أهله بين درزي لبنان وآخر سوري. «كانت لديّ تجارة مربحة. إنما بعد اندلاع الحرب، لبّيت نداء الجيش العربي السوري وتطوّعت في لجان الدفاع بوجه الإرهابيين. لا أزال متطوعاً في القوات الجوية في الجيش، لكني اضطررت أخيراً لأن أعمل سائق أجرة بعد ارتفاع الأسعار». ليس التزامه بالجيش السبب الوحيد لعدم عودته إلى لبنان «الانتماء يظل أكبر».
تنمّر وتمييز
المسنّ أو الطفل السوري لم يفلت من ذلك السلوك، حتى لو كانت والدته لبنانية. في صور خلال العام الدراسي الماضي، رفضت مديرة إحدى المدارس الرسمية تسجيل أولاد فاطمة ضمن دوام ما قبل الظهر على غرار الطلاب اللبنانيين. فاطمة المتزوجة من سوري، اضطرت لنقل أولادها إلى المدرسة الرسمية بعد ارتفاع أقساط مدرستهم الخاصة. «استعنت بواسطة مهمة أجبرت المديرة على تسجيلهم. لكني في العام التالي، نقلتهم إلى مدرسة خاصة. في المدرسة الرسمية، تعرضوا للتنمّر والتمييز كأن جنسيتهم نقص. سافر زوجي إلى أفريقيا لتحسين مدخول العائلة لمنع أيّ كان من ممارسة الفوقية على أولادنا«. هل يبدّد المال العنصرية؟. «القوي هنا من يملك المال. سواء أكان سورياً أم لبنانياً». زوجها كان صاحب نفوذ، يملك محالَّ تجارية عدة ولديه عشرات الموظفين اللبنانيين. هي كانت واحدة منهم قبل أن يتعرّض للنصب من قبل صديقه السوري الذي نزح إلى لبنان بعد الحرب. لدى فاطمة أقرباء يعملون ويقيمون في دمشق. تنقل عنهم «ارتياحهم بالعيش هنا من دون تعرّضهم للتمييز على غرار ما يتعرض له سوريو لبنان».
حقد قديم؟
خلف بسطة في شارع متفرّع من ساحة المرجة، يجلس شاب ومسنان قبيل موعد الإفطار. الشاب يخدم في مركز الشرطة الخلفي ويمضي وقتاً مع المسنين اللذين نزحا من دير الزور مع بداية الحرب، ليفتتحا بسطة في دمشق. في رمضان، يبيع المسنان يخنة الفاصولياء لعابري السبيل والمتسوّلين الذين تضاعف عددهم في السنوات الأخيرة. يحضران الطعام على الرصيف بإذن من آمر مركز الشرطة، قبل أن يناما على رصيف آخر. يفطران على ما بقي من علب لم تُبع، مع ربطة خبز يقدمها لهما جيرانهما العسكر. برغم سوء الأحوال وإعاقة المسنّ الجسدية، لم يفكرا بالنزوح إلى لبنان. «أنتم لا تحبوننا. شو عاملينلكم!» تقول السيدة. فيما يستفسر زوجها عن حقيقة ما قيل له بأنه «يمكنه الحصول على بطاقة لاجئ تمكنه من الاستشفاء، إذا دفع أموالاً لمافيات النزوح». تقاطعه زوجته لتقول: «كلّ سوري هو نازح بعد الحرب، حتى لو بقي في بلده». بسهولة، تصل المشاعر السلبية اللبنانية تجاه السوريين إلى ما خلف الحدود. «الحقد ضد السوري قديم جداً قبل أزمة النزوح»، يقول الشرطي ملمّحاً إلى «أداء الجيش السوري في لبنان وبعض المسؤولين وصولاً إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
يستعرض الشرطي شواهد عدة «للفضل السوري على اللبنانيين من الشغّيلة الذين يدعمون الاقتصاد إلى استضافة النازحين في حرب تموز 2006». يشير إلى شارع قريب سُمي منذ سنوات طويلة باسم «سناء محيدلي» الاستشهادية الجنوبية التي استهدفت حاجزاً للاحتلال الإسرائيلي عند معبر باتر بين جزين والشوف. يتصدى له زائر لبناني ليلفت نظره بأن «الشغّيلة السوريين لا يعملون بالسخرة وهم بفضل لبنان عمّروا قصوراً واشتروا مزارع في مسقط رأسهم. أما النازحون من حرب تموز فلم يطيقوا البقاء بعيداً عن أرضهم يوماً واحداً بعدما انتهت الحرب!».