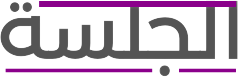لا تزال المنطقة ومن ضمنها لبنان تنتظر آفاق وتداعيات الإتفاق السعودي الإيراني. من الواضح أن وتيرة الإتفاق سريعة، خصوصاً بالنظر إلى ما يجرى في اليمن، والتطورات المتسارعة التي يشهدها الملف السوري على الرغم من عدم الوصول حتى الآن إلى اتفاق على دعوة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى القمة العربية في الرياض.
سوريا مقابل اليمن
وما هو لافت للإنتباه، أنه بعيد الإعلان عن الإتفاق السعودي الإيراني تسارعت وتيرة التحركات الأميركية باتجاه السعودية من خلال زيارات متعددة ولقاءات جرى خلالها البحث في ملفات كثيرة، أبرزها إضافة إلى الإتفاق، دخول الأميركيين على خطّ لجم الإندفاعة باتجاه دمشق.
كان لبنان يفترض أنه سيكون ثاني الملفات على سلّم الأولويات الإيرانية السعودية. أي أن البحث في تفاصيله سيأتي بعد ملف اليمن، إلا أن ما ظهر هو العكس من خلال تركيز الإهتمام بالملف السوري، لا سيما أن الإيرانيين سعوا بكل جهدهم إلى تطوير التواصل السعودي السوري ورفعه إلى المستوى السياسي بعد الأمني، وهذا ما اجتمع عليه الإيرانيون مع الروس والصينيين. يعني ذلك أن لبنان لم يكن مقابلاً لملف اليمن، إنما سوريا هي المقابل.
وفي السياق، لا بد من تسجيل ملاحظة أساسية تتعلق بمدى إمكانية تطبيق هذا الإتفاق واستمراره، والتساؤل المشروع حول موانع كثيرة قد تحول دون تطبيقه، أو تؤدي إلى تخريبه. وهذا احتمال قائم من البوابتين الأميركية والاسرائيلية.
الإنعكاس على لبنان
ولكن في حال سلك الإتفاق طريقه إلى التطبيق، فكيف سيكون انعكاسه على لبنان عندما يحين وقته؟ حتى الآن لا يزال الموقف السعودي على حاله إزاء المواصفات المطروحة وهو ما جرى إبلاغه للفرنسيين مجدداً الأسبوع الفائت. وقد كان التعاطي السعودي مع الملفين السوري واللبناني متشابهاً لجهة فرض الشروط الواجب تطبيقها للبحث في سبيل إعادة العلاقات والإستثمار أو تقديم المساعدات. وصحيح أن الشروط السعودية للأسد والتي كشفتها المدن قبل فترة، لا تزال على حالها وقد وردت في البيان المشترك بعد لقاء وزيري خارجية البلدين، وكذلك وردت في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا في الرياض، إلا أن اللهجة تغيّرت. إذ لم يذكر البيانان القرار الدولي 2254، فيما اختارا عبارة الحلّ السياسي والتسوية.
المسار السعودي-السوري
كذلك، فإن المسار السعودي السوري تسارع من خلال زيارة وزير خارجية دمشق فيصل المقداد إلى المملكة، ويأتي ذلك قبل الوصول إلى تحقيق أي من هذه الشروط، باستثناء المعلومات التي تتحدث عن إجراءات اتخذتها سوريا تتعلق بتهريب المخدرات. إنطلاقاً من هذا المسار، يبقى السؤال الأساسي عما إذا كان الإنفتاح سيبقى في سياقه السياسي والبروتوكولي من دون الإنتقال إلى مرحلة تطبيقية. وهو ما لا يمكن لأحد توقعه حتى الآن. أي أن تكون عودة فقط لأجل العودة بدون مفاعيل سياسية، فتخفف السعودية بذلك التوتر فقط، من دون الوصول إلى نتائج عملانية بما يتعلق بالشروط التي تضعها. خصوصاً ان النظام السوري هو صاحب الخبرة الأكثر في التهرب من الإلتزامات وعدم الإيفاء بها.
تعويم من دون محاسبة؟
نقطة ضعف أساسية أخرى، تتعلق بأي محاولة لتعويم النظام، وهي الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري، وعملية التهجير الممنهج التي اعتمدها في سبيل إحداث التغيير الديمغرافي، وبالتالي أي تطبيع معه بدون محاسبة سياسية أو تقديم ثمن كبير فهذا يعني “مباركة” لما قام به، ومكافأة للجهات التي دعمته ورعته. وهذا بحال حصل يتعارض مع التصور الذي يُبنى حول السعودية باعتبارها تريد أن تكون صاحبة القرار العربي أو قائدة المنطقة، علماً أن ذلك لا بد من توفر مقوماته والتي تقتضي التوازن وليس تغليب طرف على آخر، كما سيحصل بموجب أي تعويم للنظام في دمشق.
هل تتراجع السعودية عن موقفها؟
لا يمكن إغفال إشكالية أساسية تحتاج إلى حلّ طلاسمها أيضاً، وهي أن السعودية تريد حلّ الأزمة اليمينة إنطلاقاً من دوافع الأمن القومي السعودي للتفرغ للإستثمار والشؤون الداخلية. وهذا ما يتطابق مع السعي إلى دمشق لوقف تهريب المخدرات وضبط الحدود، وهو أيضاً ما ينطبق على لبنان فقط. وبالتالي هل يكون الإهتمام السعودي بلبنان وسوريا ينطلق من هذا الهدف لا غير؟ ما يعني عدم تطابق ذلك مع أي اهداف سياسية.
بالإرتكاز إلى وجهة النظر هذه ثمة من يراهن في لبنان على عدم استمرار السعودية على شروطها الواضحة أو على المواصفات المطروحة حول الإستحقاق الرئاسي والتي حتى الآن تعيق وصول سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية على الرغم من تمسك حلفائه به وسعي موسكو وباريس إلى التسويق له.
هنا لا بد من ترقب الموقف الأميركي الذي لا بد أنه سيضع محددات واضحة حيال الوضعين في سوريا ولبنان.